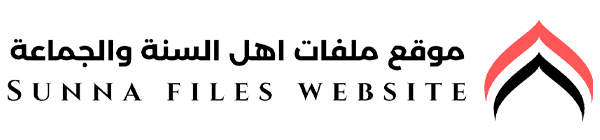يقدّم الغرب نفسه منذ عقود بوصفه الحارس العالمي لحقوق الإنسان، وراعي حرية التعبير، وضامن المساواة بين الأفراد. هذا الخطاب يتكرر في خطابات السياسيين، وتقارير المنظمات الدولية، ومنصات الإعلام الكبرى، حتى بات يبدو وكأنه حقيقة غير قابلة للنقاش.
غير أن هذا الادعاء ينهار عند أول اختبار جاد.
ففي السنوات الأخيرة، برز تناقض صارخ لا يمكن تجاهله: الكوفية الفلسطينية تُعامل بوصفها تهديدا أمنيا، بينما تُرفع راية المثلية على مباني الدولة والمؤسسات الرسمية. رمز يُلاحق ويُمنع ويُشيطن، وآخر يُفرض ويُروَّج له ويُقدَّم كمعيار للتقدم والتحضر.
هذه ليست مصادفة. وليست مسألة حرية تعبير. بل هي سياسة.
الكوفية الفلسطينية: من رمز ثقافي إلى هدف سياسي
الكوفية الفلسطينية ليست اختراعا حديثا ولا شعارا حزبيا. هي لباس ارتبط بالأرض، وبالفلاح الفلسطيني، وبالذاكرة الجمعية لشعب يواجه الاستعمار الاستيطاني منذ أكثر من قرن. ارتداها العمال والطلاب، والشيوخ والشباب، والمقاومون والمثقفون، بوصفها تعبيرا عن الانتماء والكرامة والاستمرار.
لكن في الغرب، تغيّرت طريقة التعامل معها.
في أستراليا، طُلب من طلاب في مدرسة ثانوية بسيدني خلع الكوفية خلال حفل تخرج بحجة “أسباب أمنية”. في الولايات المتحدة، تعرّض موظفون في شركات كبرى لعقوبات بسبب ارتداء الكوفية أو التعبير عن تضامنهم مع فلسطين. في نيويورك، قدّم عدد من العاملين في متحف معروف استقالاتهم بعد صدور تعليمات تمنع ارتداء الكوفية داخل مكان العمل. وحتى في تونس، أُثير جدل واسع بعد منع طلاب من ارتدائها أثناء الامتحانات.
هذه الوقائع ليست حوادث فردية معزولة. إنها نمط متكرر.
فالكوفية تُسمح بها فقط عندما تُفرغ من معناها، أو تُقدَّم كإكسسوار أزياء، أو تُفصل عن سياقها السياسي والتاريخي. أما حين تصبح تعبيرا عن هوية فلسطينية حية، أو رفضا للاحتلال، فإنها تُصنَّف فورا كرمز إشكالي أو “تحريضي”.
المشكلة إذن ليست في الرمز نفسه، بل في ما يذكّر به.
راية المثلية: من هامش اجتماعي إلى عقيدة مؤسسية
في المقابل، شهدت راية المثلية تحولا جذريا في مكانتها داخل المجتمعات الغربية. لم تعد مجرد تعبير عن فئة تطالب بالحماية، بل تحولت إلى رمز رسمي تتبناه الدولة وتفرضه المؤسسات.
في مدن غربية عديدة، تُرفع هذه الراية على مباني البلديات، والسفارات، والجامعات، وحتى القواعد العسكرية. تُدرج في المناهج التعليمية، وتُدمج في سياسات الشركات، وتُقدَّم كدليل على “التقدم القيمي”. بل إن بعض المدن اعتمدتها رمزا رسميا للمدينة، في تحدٍّ صريح لأي اعتراض مجتمعي أو ديني.
في الفعاليات الدولية والثقافية، يُسمح بهذه الراية دون قيود، بينما تُمنع الرموز الفلسطينية أو تُصادَر. هذا ليس حيادا. هذا فرض أيديولوجي.
القبول براية المثلية بات شرطا غير معلن للاندماج في الفضاء العام الغربي، أما الاعتراض عليها فيُصوَّر تلقائيا بوصفه تطرفا أو كراهية.
تبييض الاحتلال: حين تُستعمل المثلية كغطاء سياسي
لفهم هذا التناقض، لا بد من التوقف عند مفهوم “تبييض الانتهاكات عبر الخطاب الحقوقي”، أو ما يُعرف إعلاميا بـ”الغسل الوردي”.
تتبنّى إسرائيل هذا الأسلوب بوضوح. فهي تسوّق نفسها في الغرب كدولة “تقدمية” تحترم حقوق المثليين، وتبرز مشاهد المسيرات والاحتفالات في تل أبيب، بينما تُسقِط في الوقت ذاته قنابل ممولة غربيا على غزة، وتهدم البيوت في الضفة، وتحاصر شعبا بأكمله.
هذا التناقض ليس عرضيا. بل هو مدروس.
من خلال الترويج لحقوق المثلية، تسعى إسرائيل إلى كسب التعاطف داخل الدوائر الليبرالية الغربية، وتقديم نفسها كجزء من “العالم المتحضر”، في مقابل تصوير الفلسطيني، وغالبا المسلم، بوصفه “متخلفا” أو “غير متسامح”.
وبذلك، يتحول نقد الاحتلال إلى تهمة أخلاقية، وتُربط مقاومة الاستعمار بالرجعية، بينما يُقدَّم دعم المشروع الصهيوني بوصفه موقفا إنسانيا.
هندسة الوعي: الرموز كسلاح ناعم
الرموز ليست بريئة. إنها أدوات لتشكيل الوعي العام.
حين يُحتفى براية معينة ويُجرَّم رمز آخر، فإن الرسالة واضحة: هناك هوية مقبولة، وأخرى مرفوضة. هناك قيم تُكافأ، وأخرى تُعاقَب.
بهذا الأسلوب، يعاد إنتاج الهيمنة الغربية ثقافيا وأخلاقيا. تُحمى الجرائم تحت غطاء “التقدم”، وتُقمع الأصوات المناهضة للاستعمار باسم “الأمن” أو “التعايش”.
وفي الوقت نفسه، تُستغل الفروقات الثقافية لإضعاف التضامن الإسلامي والعربي، عبر تصوير القيم الإسلامية بوصفها عائقا أمام “الحداثة”.
الإسلام: وضوح أخلاقي في زمن الالتباس
الإسلام لا يعاني من هذا الارتباك.
موقفه من الفطرة، والأسرة، والجنس، والأخلاق، موقف واضح لا لبس فيه. لا يقر أيديولوجيا المثلية، ولا يقبل النسبية الأخلاقية التي تخضع الحق للهوى أو للقوة السياسية.
وفي الوقت ذاته، لا يفصل الإسلام بين الأخلاق والعدل. فالوقوف مع المظلوم، ورفض الاحتلال، ومقاومة الاستعمار، ليست قضايا انتقائية، بل أصول راسخة.
إن تجريم الكوفية الفلسطينية، وهي رمز كرامة ومقاومة استعمار، مقابل تقديس راية تخالف الفطرة، ليس حيادا ولا دفاعا عن الحقوق. إنه انحياز صريح لمنطق القوة.
الكوفية باقية
الكوفية ليست مجرد قماش. هي ذاكرة شعب، وعنوان صمود، وشهادة على جريمة مستمرة.
ومهما حاولت المؤسسات الغربية إسكات هذا الرمز، أو تشويهه، أو تجريده من معناه، فإنه سيبقى حاضرا، لأن جذوره مغروسة في الأرض، لا في مكاتب السلطة.
والكوفية ستظل راية المظلومين، مهما حاولوا إسكاتها.