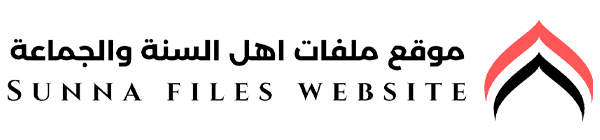المُطَّلِعُ على سيرة النبي محمدٍ ﷺ بعد البِعثة وقبلَها وبعدها يزدادُ إيمانُه وحبُّه للنبي ﷺ حتى يُحبَّه أكثرَ من نفسِه، وإن كان كافِرًا أسلمَ أو أعرضَ وهو مُوقِنٌ بأنه رسولُ رب العالمين.
ولئن فاتَ مَن بعد الصحابةِ مُشاهَدةُ النبي ورُؤيتُه ﷺ، فقد وصفَ الصحابةُ – رضي الله عنهم – خلقَه وخُلُقَه كأنا نراه رأيَ العين ﷺ، لنتخلَّقَ بأخلاقِه ما استطَعنا.
عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالبٍ – رضي الله عنه – في وصفِ النبي ﷺ
قال: “لم يكُن بالطويل المُمغَّط، ولا بالقصير المُتردِّد، كان رَبعةً من القَوم، ولم يكُن بالجَعْد القَطَط ولا بالسَّبْطِ، وكان في وجهِه تدوير، أبيضُ مُشرَّب – يعني: بحُمرة -، أدعَجُ العينين – يعني: سوادٌ في بياض -، أهدَبُ الأشفار، جميلُ المُشاش والكَتَد – يعني: ضخم المفاصِل -، من رآه بديهةً هابَه، ومن خالطَه أحبَّه، لم يُرَ قبلَه ولا بعدَه”؛ رواه الترمذي.
وعن أنس – رضي الله عنه – قال: “كان النبي ﷺ أحسنَ الناسِ، وكان أشجعَ الناس، وكان أجودَ الناس”؛ رواه البخاري ومسلم.
وعن الحسن بن علي – رضي الله عنهما – قال: سألتُ خالي هندَ بن أبي هالَة – وكان وصَّافًا – عن صفة رسول الله ﷺ، فقال: “كان رسولُ الله ﷺ فخمًا مُفخَّمًا، يتلألأُ وجهُه تلألُؤَ القمر ليلةَ البَدر، أطولَ من المربُوع، وأقصرَ من المُشدَّب، عظيمَ الهامَة – أي: الرأس -، رجِلَ الشَّعر، إذا انفرَقَت عقيصتُه فرقَ، وإلا فلا يُجاوِزُ شعرُه شحمةَ أُذُنه إذا هو وفَّرَه، أزهرَ اللون، واسِع الجَبين، أزجَّ الحواجِب، سوابِغ من غير قرَن – أي: دقيقُ الحواجِب في تمامٍ وسُبُوغٍ – بينهما عِرقٌ يُدرُّه الغضبُ.
أشعرَ الذِّراعَين والمَنكِبَين وأعالي الصدر، طويلَ الزَّندَين، رَحبَ الرَّاحة، سبطَ القَصَب – بمعنى: تامّ العِظام -، شَثْنَ الكفَّين والقَدَمَين – أي: ضخمهما في حُسنٍ -، سائلَ الأطراف، خَمصَان الأخمَصَين، ينبُو عنهما الماء، إذا زال زالَ تقلُّعًا، ويخطو تكَفُّؤًا، ويمشِي هونًا، ذَريعَ المشيَة، إذا مشَى كأنما ينحَطُّ من صَبَب.
وإذا التَفَتَ معًا خافِضَ الطَّرف، نظرُه إلى الأرض أطولُ من نظره إلى السماء، جُلُّ نظَرِه المُلاحَظة، يسُوقُ أصحابَه، ويبدأُ من لقِيَه بالسلام”.
قلتُ: صِف لي منطِقَه. قال: “كان ﷺ مُتواصِلَ الأحزان، دائِمَ الفِكرة، ليس له راحة، ولا يتكلَّم في غير حاجةٍ، طويلَ السُّكُوت، يفتَتِحُ الكلامَ ويختِمُه بأشداقِه، ويتكلَّم بجوامِع الكَلِم، فصلاً لا فُضول فيه ولا تقصير، دمِثًا ليس بالجافِي ولا بالمَهين.
يُعظِّمُ النعمةَ وإن دقَّت، لا يذُمُّ ذواقًا ولا يمدحُه، ولا تُغضِبُه الدنيا ولا ما كان لها، فإذا تُعرِّض للحق لم يعرِف أحدًا، ولم يقُم لغضَبِه شيءٌ، ولا يغضَبُ لنفسِه ولا ينتصِرُ لها، إذا أشارَ أشارَ بكفِّه كلِّها، وإذا تعجَّبَ قلَّبَها.
وإذا تحدَّثَ اتَّصَلَ بها فضربَ بباطِنِ راحَتِه اليُمنَى باطِنَ إبهامِه اليُسرَى، وإذا غضِبَ وأعرضَ أشاحَ، وإذا ضحِكَ غضَّ طرفَه، جُلُّ ضحِكِه التبسُّم، ويفتَرُّ عن مثلِ حبِّ الغَمَام.
فكتمتُها الحُسينَ زمانًا، ثم حدَّثتُه، فوجدتُّه قد سبَقَني إليه، فسألَني عما سألتُه، ووجدتُّه سألَ أباه عن مدخَلِه ومجلِسِه وشكلِه، فلم يدَع منه شيئًا”.
قال الحُسين – رضي الله عنه -:
لا يُذكر عنده إلا ذلك، ولا يقبَلُ من أحدٍ غيره، يدخُلون رُوَّادًا، ولا يتفرَّقون إلا عن ذَواقٍ – أي: إطعام -، ويخرُجون أذِلَّة».
قال: فسألتُه عن مخرَجه: كيف كان يصنعُ فيه؟ فقال: “كان رسولُ الله ﷺ يخزِنُ لسانَه إلا مما يَعنيهم، ويُؤلِّفُهم ولا يُفرِّقُهم – أو قال: ولا يُنفِّرُهم -، فيُكرِمُ كريمَ كل قومٍ ويُولِّيه عليهم، ويُحذِّرُ الناسَ من كل شرٍّ”.
قال: “ويحذَرُ الناسَ ويتحرَّسُ منهم من غير أن يطوِيَ عن أحدٍ منهم بِشرَه ولا خُلُقَه.
يتفقَّدُ أصحابَه، ويسألُ الناسَ عما في الناس، ويُحسِّنُ الحسنَ ويُصوِّبُه، ويُقبِّحُ القبيحَ ويُوهِّنُه، مُعتدِلَ الأمر غيرَ مُختلِف، لا يغفُل مخافةَ أن يغفُلوا أو يملُّوا، لكل حالٍ عنده عتَاد، لا يُقصِّرُ عن الحق ولا يُجاوِزُه، الذين يلُونَه من الناس خِيارُهم، وأفضلُهم عنده أعمُّهم نصيحةً، وأعظمُهم عنده منزلةً أحسنُهم مُواساةً ومُؤازرَة”.
فسألتُه عن مجلسِه، فقال: “كان ﷺ لا يجلِسُ ولا يقومُ إلا على ذِكر، ولا يُوطِنُ الأماكِن وينهَى عن إيطانِها، وإذا انتهَى إلى قومٍ جلسَ حيث ينتهِي به المجلِس، ويأمُرُ بذلك، ويُعطِي كل جُلسائِه نصيبًا، حتى لا يحسِبُ جليسُه أن أحدًا أكرمَ عليه منه، من جالسَه أو قاومَه في حاجةٍ صابَرَه حتى يكون هو المُنصرِف، ومن سألَه حاجةً لم يرُدَّه إلا بها أو بميسورٍ من القول.
قد وسِعَ الناسَ بسطُه وخُلُقُه، فصار لهم أبًا، وصارُوا عنده في الحق سواءٌ. مجلِسُه مجلسُ حلمٍ وحياءٍ، وصبرٍ وأمانةٍ، لا تُرفعُ فيه الأصوات، ولا تُؤبَّنُ فيه الحُرُم، ولا تُخشَى فلَتَاتُه، مُتعادِلين مُتواصِين بالتقوى مُتواضِعين، يُوقِّرون الكبيرَ ويرحَمون الصغير، ويُؤثِرون ذوِي الحاجة، يحفَظون الغريب”.
قال: قلتُ: كيف كانت سبيرتُه في جُلسائِه؟ قال: “كان ﷺ دائِمَ البِشر، سهلَ الخُلُق، ليس بالجافِي، ليِّن الجانِب، ليس بفظٍّ ولا غليظٍ، ولا صخَّاب، ولا فاحِش ولا عيَّاب، ولا مدَّاح، يتغافَلُ عما لا يشتهِي، ولا يُوئِسُ منه.
لا يُخيِّبُ فئةً، قد ترك نفسَه من ثلاث: المِراء، والإكثار، وما لا يَعنيه.
وتركَ الناسَ من ثلاث: كان لا يذُمُّ أحدًا، ولا يُعيِّرُه، ولا يطلُبُ عورتَه، ولا يتكلَّم إلا فيما يرجُو ثوابَه، وإذا تكلَّم أطرقَ جُلساؤُه كأنَّما على رُؤوسِهم الطير، وإذا سكَتَ تكلَّموا، ولا يتنازَعون عنده الحديثَ، من تكلَّم عنده أنصَتُوا له حتى يفرغ.
قال: قلتُ: كيف كان سكوتُه؟ قال: “كان سكوتُه ﷺ على أربع: على الحلمِ، والحذَر، والتقدير، والتفكُّر.
فأما تقديرُه ففي تسوية النَّظر والاستِماع بين الناس، وأما تذكُّره – أو قال: تفكُّره – ففيما يبقَى ويفنَى. وجُمِع له الحِلمُ في الصبر، فكان لا يُغضِبُه شيءٌ، ولا يستفِزُّه، وجُمِع له الحَذَرُ في أربع: أخذُه بالحسَن ليُقتَدَى به، وتركُه القَبيح ليُنتهَى عنه، واجتِهادُ الرأي فيما أصلحَ أمَّتَه، والقيامُ لهم بما جمع لهم الدنيا والآخرة”؛ رواه الطبراني في “الكبير”، ولبعضِ ألفاظِه شواهِدُ في “الصحيحين”، و”السنن الأربع”.
ولا أعظمَ من وصف الله لخليلِه محمدٍ ﷺ بالخُلُق العَظيم، قال الله تعالى: (وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ) [القلم: 4]، وهو وصفٌ لم يُوصَف به أحدٌ قبلَه، وهذا أعظمُ رِفعةٍ له ﷺ ولأمَّته.
وحتى قبل الرسالة كانت سيرتُه ﷺ آياتٍ وعجائِب من الفضائل والمكارِم والسَّجايا العُليا، فكان الناسُ يُسمُّونَه الأمين، وحفِظَه الله من سُوءِ وشرِّ الجاهليَّة ولوثَاتها، فلم يجِد أعداؤُه سقطةً أو هفوَةً يُعيِّرُونَه أو يسُبُّونَه بها، مع شدَّة حِرصِهم واطِّلاعهم على كل شيءٍ من حالاتِه، فقد برَّأَه الله من كل عيبٍ ونقيصةٍ