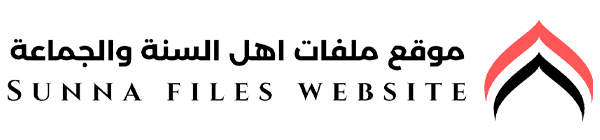منذ اللحظة التي أُعلن فيها عن قيام دولة «إسرائيل» عام 1948، أدرك منظّرو المشروع الصهيوني حقيقة لا يجهلها أي مؤرخ نزيه: إنّ هذا الحلم المسروق لن يصمد طويلًا إذا بقيت الأرض مكتظةً بأهلها الأصليين. طوال أكثر من سبعة عقود، تابع العالم مشاهد الطرد والمذابح والهدم والمستوطنات — كل ذلك تحت شعار «الدفاع عن النفس» الذي يخفي مشروعًا واحدًا: إعادة رسم فلسطين لتتناسب مع الأسطورة.
ومع ذلك، بقيت غزة استثناءً مستعصيًا. هذه الرقعة الساحلية الصغيرة، المحاصَرة بالأسلاك الشائكة والأبراج والحصار، تحتضن أكثر من مليوني فلسطيني في ما يوصف حتى في تقارير المنظمات الغربية بأنه «أكبر سجن مفتوح في العالم». فلماذا لا يُترَك أهل غزة وشأنهم؟ ولماذا هذا الإصرار المستمر على إذلالهم وتجويعهم وقصفهم بلا هوادة؟ الجواب عند من يفهمون العقل الصهيوني بسيط وصادم: إنهم لا يستطيعون بناء «القدس القادمة» ما لم تُفرَّغ غزة.
الشرعية الدينية لهذه الجريمة أقدم من نشأة إسرائيل الحديثة ذاتها. في سفر التكوين 15:18، يُعلن التوراة: «لِنَسْلِكَ أُعْطِي هذِهِ الأَرْضَ، مِنْ نَهْرِ مِصْرَ إِلَى النَّهْرِ الْكَبِيرِ، نَهْرِ الْفُرَاتِ». هذه «الأرض الموعودة» تمتد من النيل إلى الفرات — أي أنّ غزة، بل ومصر وسيناء، داخل حدود الوهم التوراتي الذي لم يُنسَ لحظة في أدبيات التيارات الدينية المتطرفة في إسرائيل. يُضيف الزوهار بُعدًا أشد وحشية حين يُصنّف العرب بأنهم «حمير المسيح»، خُلقوا لخدمة الشعب المختار أو الزوال من أمامه.
الخطة السياسية ليست أقل وضوحًا. في الثمانينيات، نشر المحلل الاستراتيجي عوديد ينون وثيقته المعروفة بـ «خطة ينون» التي نصّت صراحةً على تفكيك العالم العربي إلى دويلات طائفية ضعيفة. أحد أبرز مفاصل الخطة: تحييد الكتلة الفلسطينية عبر الحصار أو التهجير الجماعي. غزة، بتركيبتها الديمغرافية الهائلة وذاكرتها العنيدة وقيمتها الرمزية، كانت دائمًا شوكةً في حلق هذا المخطط. وقد قال مسؤول أمني إسرائيلي سابق في تسريب صحفي: «نستطيع أن نقصف غزة ونعيدها إلى العصر الحجري، لكننا لا نعرف كيف نجعلها تختفي… حتى الآن.»
لكن الحلم لا يزال قائمًا — بل صار أكثر وقاحةً في السنوات الأخيرة. وزراء صهاينة متطرفون أمثال سموتريتش وبن غفير لم يعودوا يخجلون من الحديث علنًا عن «الهجرة الطوعية» — المصطلح المخفف للتطهير العرقي. في الأسابيع الأولى من عدوان 2023–2024، كشفت وثائق مسربة عن نقاشات في أروقة الحكومة الإسرائيلية لوضع خطة لدفع مليوني فلسطيني من غزة نحو صحراء سيناء. الهدف: جعل غزة أرضًا محروقة خالية من سكانها، وتحويلها إلى «منطقة عازلة» تحمي المشروع المقدّس للقدس الكبرى.
المثير أنّ هذه الأفكار لم تعد تُهمَس في زوايا مظلمة. صارت تُكتب في أوراق سياسات، ويغرد بها المستوطنون، وتناقش في الكنيست. حتى الصحف الإسرائيلية الرئيسية لم تتردّد في نشر مقالات رأي تطالب بأن يُحلّ «المشكلة الديمغرافية» لغزة بالتطهير أو التجويع البطيء حتى يرحل الناس طوعًا. السياسي الإسرائيلي أفي ديختر لخص الرؤية بصراحة: «يجب أن تنكمش غزة. الأرض باقية، أما الناس فلا.»
ولماذا غزة بالذات؟ ولماذا الآن؟
لأن غزة ليست مجرد مخيمات بائسة وأحياء مدمرة. غزة هي شاهد حي يفضح الأسطورة الصهيونية الكبرى: أنها أرض بلا شعب. غزة هي المفتاح الأخير الذي يقف بين أحلام المستوطنين وحقيقة أن القدس لا يمكن تهويدها بالكامل إذا بقيت غزة صامدةً على الخريطة.
الرابط أعمق من الجغرافيا. في عقلية الصهيونية الدينية، لا تكتمل «الفداء الأرضي» إلا بتطهير الأرض من أهلها الأصليين. إن القوة التي تدفع المستوطن لطعن الفتى في الخليل، هي نفسها التي تقود الطائرات لتقصف رفح وخان يونس. إنها نفس العقيدة، ونفس الجرافة، ونفس الدم البارد.
أمّا الغرب، الذي يتباكى على حقوق الإنسان صباحًا ومساءً، فيرى كل ذلك ولا يفعل إلا ما يفعله دائمًا: توقيع المزيد من صفقات السلاح، استخدام الفيتو ضد قرارات وقف إطلاق النار، وشرعنة جريمة الاحتلال تحت عناوين «محاربة الإرهاب». يضيئون برلماناتهم بألوان قوس قزح لأجل أوكرانيا، لكن الكوفية الفلسطينية تظل موضع شبهة وربما جريمة.
إنّ الخطة لم تعد سرًا، ولا جديدة. إنها نفس المخطوطة القديمة: مزّق، دمّر، شيطن، ثم أفرغ الأرض حتى يتطابق الواقع مع النص.
لكن غزة ليست صفحة بيضاء تُمحى. تحت الركام، في الأنفاق، في مفاتيح البيوت التي ورثها الأبناء عن الأجداد، رسالة واحدة لا تزال تنبض: قد تحترق الأرض، لكن شعبها لا يزول.
في عالم يصرّ على محو فلسطين من خرائطه وذاكرته، ستظل غزة شاهدًا عنيدًا: إنّ القدس القادمة لا تُبنى على مقابر الأبرياء.